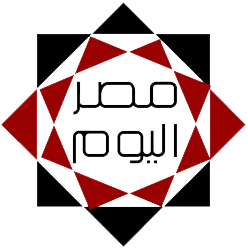تنقّل قارئاً بنهمٍ بين عوالم الرواية العربية والعالمية، كان يؤجل الكتابة مكرهاً -كما قال-، وفي السنوات الأخيرة ذاع صيته، وانتشرت أعماله الروائية بشكل لافت، ليتوّج مسيرته في الكتابة الإبداعيّة بفوز روايته «ابنة ليليت» بتحويلها إلى سيناريو سينمائي ضمن مبادرة جمعية الأدب المهنيّة في مشروع تحويل الأعمال الروائية إلى سيناريو سينمائي، وليزيد حضوره في المشهد الثقافي.
يعيد الفضل في تشكّل وعيه للقراءة والوظيفة التي صقلت حياته، ومنحته مهارات حيوية في فهم النفس البشرية، وكان لهذه التجربة دور كبير في بناء شخصيات أعماله الروائية، وتخطيط الحوارات، والتعامل مع المواقف المعقّدة.
الكثير من هذه القضايا في حوارنا مع الروائي أحمد السماري.. فإلى نصّ الحوار..
• منذ أربع سنوات، تردّد اسمك في المشهد الثقافي السعودي بشكل ملحوظ، أين كنت قبل هذا التاريخ؟
•• كنتُ حيث يكون القارئ الحقيقي: غارقاً في الكتب، أتنقّل بين عوالم الرواية العربية والعالمية، أقرأ بنهمٍ تجاوز الألف رواية في السنوات العشر التي سبقت الكتابة، وكأنني أبني مكتبة داخل رأسي، أو أُهيّئ نفسي بصبرٍ طويل لليوم الذي أكتب فيه بشروط الفن بعيداً عن استعجال الظهور.
الكتابة بالنسبة لي لم تكن غائبة، لكنها كانت مؤجلة قسراً وسط زحام الحياة العملية ومسؤوليات المهنة التي لم تترك لي من الوقت إلا فسحات صغيرة انتزعتها بصعوبة لأجل القراءة، بينما الكتابة -وهي فعل أكثر تطلّباً وعمقاً- كانت تنتظر مساحة أرحب.
جاء التقاعد كهدية طال انتظارها. ومعه وُلدت رواية «الصريم»، أول عمل روائي كتبته بعد خروجي من دوّامة الجداول والمهمات اليومية. كان الزمن قد نضج داخلي، والأفكار اكتمل اختمارها، فبدأت الكتابة بعد تراكم مخزون معرفي وفكري وخبرات حياتية تشكّلت على مهل، وصار اليوم يشق طريقه إلى القرّاء.
• كيف تشكّل وعي أحمد السماري الأدبي؟
•• تشكّل وعيي الأدبي عبر طبقات متعددة، بدأ من النص المقدّس وامتدّ إلى تجارب القراءة العميقة، وانعكس في النهاية على تجربتي كاتباً.
في البداية، كانت تلاوة القرآن الكريم وحفظ بعض أجزائه أول تماسٍ لي مع جمال اللغة، وسحر البيان، وقدرة الكلمات على أن تُهزّ القلب وتضيء العقل. هذا الأثر المبكر ظلّ حيّاً في ذاكرتي اللغوية والوجدانية.
ثم جاءت محبة القصص والحكايات، وكان لأستاذي علي الزهراني -مدرس التربية الفنية في مدرسة أحمد بن حنبل الابتدائية بالرياض- فضل كبير، إذ كان يخصّص الحصة الثانية ليحكي لنا قصصاً معظمها من قراءاته في الأدب الشعبي والروايات العربية. تلك اللحظات غرست في نفسي حب السرد، وفتحت لي الباب نحو عوالم الحكاية.
ثم تلتها مرحلة القراءة النهمة والمكثفة، التي تجاوزت فيها خلال عشر سنوات فقط أكثر من ألف رواية عربية وعالمية، كنت أقرأ خلالها كمن يجمع أدواته قبل أن يصعد إلى المسرح. تأثرت كثيراً بنجيب محفوظ، والطيب صالح، وعبدالرحمن منيف، وإبراهيم الكوني، وقرأت بنهمٍ لكارلوس زافون، وإيزابيل الليندي، وباولو كويلو، وماريو بارغاس يوسا، وأليف شافاق، وغابرييل غارسيا ماركيز، وغيرهم كثير.
كما تابعت بإعجاب واهتمام إنتاج عدد من الروائيين السعوديين البارزين؛ الذين أسهموا في رفع سقف الطموح الفني للرواية السعودية، أمثال: عبده خال، ويوسف المحيميد، ومحمد حسن علوان، وأميمة الخميس، ومحمد المزيني، وغيرهم الكثير.
لكن وعيي لم يتشكّل بالقراءة وحدها، بل صقلته أيضاً حياتي المهنية الطويلة، التي منحتني مهارات حيوية في فهم النفس البشرية؛ فقد علّمتني الإدارة التوقيت المناسب لبدء أي مشروع -وهذا ما حدث مع الكتابة تماماً- كما منحتني فراسة اختيار الأشخاص والتعامل مع الشخصيات المختلفة، وتحليل ردود أفعالها. وقد كانت هذه التجربة، من حيث لم أشعر، تدريباً طويل المدى على بناء الشخصيات الروائية، وتخطيط الحوارات، والتعامل مع المواقف المعقّدة.
ولهذا، حين دخلت عالم الكتابة، كان عقلي قد تحول إلى خليط ناضج من التراكم القرائي، والتجربة الحياتية، والانتباه الحاد للتفاصيل الإنسانية. أكتب اليوم بما يشبه رحلتي كلها: هادئاً حيناً، مندفعاً حيناً، وبكثير من التأمل فيما وراء النص.
• في ظل حضورك اللافت في الندوات والأمسيات والملتقيات، وفي شبكات التواصل الاجتماعي بشكل كبير، متى تجد الوقت للقراءة والكتابة؟
•• السؤال في محلّه، إذ قد يبدو للمتابع أن الحضور الثقافي في الندوات والمنصات الرقمية يزاحم الوقت المخصص للقراءة والكتابة، لكنني أراه في حقيقته امتداداً طبيعياً للرحلة الأدبية، لا قطيعة معها.
فالكتابة لا تحدث فقط حين نمسك القلم، بل حين نُصغي للعالم، ونتفاعل مع نبض المجتمع الثقافي، ونراقب تغيراته، ونتعلّم من حواراته وأسئلته. هذه الأمسيات واللقاءات تمدّني بطاقة فكرية مختلفة، وتوسّع من أفق الوعي.
أما عن القراءة والكتابة، فهما أولوية يومية لا تفاوض حولها. أُخصّص لهما وقتاً منتظماً على طول النهار، كما اعتدت منذ عملي في القطاع الخاص، وغالباً في الصباح الباكر أو في لحظات السكون بعد الزحام. التقاعد منحني فسحة زمنية أوسع، لكن ما يجعل الجمع بين هذه العوالم المتوازية ممكناً هو التنظيم والانضباط الذاتي في إدارة الوقت، وهما من أثمن ما تعلمته من تجربتي الإدارية.
ولا يمكنني الحديث عن بداياتي دون أن أُشير-بكل امتنان وفخر- إلى مبادرة «الشريك الأدبي» التي أطلقتها هيئة الأدب والنشر والترجمة؛ لقد كانت النافذة الأولى التي قُدّمت من خلالها إلى المشهد الثقافي، وكانت الشرارة التي أوصلت صوتي إلى القرّاء، والنقاد، والصحافة الثقافية.
وسأقدّم اعترافاً هنا: لقد كانت هذه المبادرة دافعاً قوياً لتغيير نمط علاقاتي المجتمعية؛ فاستبعدت من برنامجي «الاستراحات»، والعلاقات الزائدة عن الحاجة، والمناسبات الاجتماعية المرهقة. هذا التغيير وفّر الكثير من الوقت الذي كان يُهدر دون جدوى، وبدأ يُستثمر فيما يستحق.
• أنت تكتب الرواية، ولديك ثلاث روايات لفتت إليها الأنظار، إن على مستوى القراءة وإن على مستوى النقد. وكما علمتُ، فإن روايتك الرابعة في طريقها لمعرض الكتاب القادم في الرياض. ما السمات الخاصة التي يحملها منتجك الروائي؛ كي يحظى بهذا القبول؟
•• لم أكن أتوقّع أن تجد رواياتي هذا الصدى، وهذا القبول الطيب من القرّاء، سواء على مستوى الإقبال أو التفاعل النقدي.
فالحمد لله الذي رزقني هذا، والشكر الجزيل لكل قارئ وقارئة منحوني ثقتهم، وشاركوا ملاحظاتهم، وكتبوا، وناقشوا، وأهدوني من وقتهم وجهدهم ما لم أكن أحلم به.
أما عن السمات الخاصة التي قد تكون أسهمت في هذا القبول، فأظن أن أبرزها أنني أكتب بتلقائية وصدق. لا أتكلّف، ولا أسعى لإبهار مصطنع، بل أقترب من الإنسان، وأحاول أن أعيد اكتشافه وسط الزحام، والحزن، والضجر، والأمل.
أكتب عن شخصيات «عادية» أو «مهمّشة» ظاهرياً، لكنها في العمق تحمل أسئلتنا جميعاً: من نحن؟ ولماذا نعيش بهذا الوضع؟ وما الذي نبحث عنه فعلاً؟
كما أنني أميل إلى اللغة المتزنة، التي تجمع بين البساطة والعمق، بين الجملة التي تسري كالماء، والفكرة التي تستقر في الذهن.
وأحرص على الاقتراب من الواقع دون أن أسقط في المباشرة، وأستلهم التاريخ دون أن أُحوّل الرواية إلى وثيقة، وأستدعي الحنين دون أن أغرق فيه.
أحاول أن أجعل الرواية مساحة حرة للأسئلة، لا منبراً للتقرير والوصايا.
وكل ذلك في سياق هدفي الأسمى من الكتابة: تحقيق المتعة. فأنا أؤمن أن الرواية، قبل أي شيء، وسيلة لإهداء السعادة للآخرين، ومن لا يُمتع قارئه لن يُقنعه ولا يُلامس وجدانه.
وأؤمن، دائماً، أن القارئ ذكي ومخلص، ولا يمنح إعجابه إلا لنصّ يشعر أنه كُتب له، أو عنه، أو معه. لذلك، أسعى في كل عمل جديد إلى أن أفاجئه، لا بأسلوبي فقط وهو مهم، ولكن -وهو الأهم- بفكرة روائية جديدة ومدهشة.
روايتي الرابعة «فيلق الإبل» -بإذن الله- ستكون حاضرة في معرض الرياض الدولي للكتاب 2025، وأتمنى أن تكون امتداداً لهذا المسار، واختباراً جديداً لتحدي الكتابة، وأن يجد فيها القرّاء الكرام المتعة والمعرفة والفائدة.
• من «الصريم» إلى «قنطرة» إلى «ابنة ليليت» وأخيراً «فيلق الإبل»، ما الرسالة التي يريد أحمد السماري أن يوصلها للقارئ عموماً؟
•• رسالتي الأدبية تنبع من قناعة عميقة بأن الأصالة تُستخرج من الجذور.
ولهذا، فإنني منذ بداياتي أكتب بدافع استكشاف هويتنا المحلية؛ بكل ما فيها من صحراء صامتة، وقرى بعيدة، ومدن تختزن طبقات من الحكايات والأصوات التي لا تزال تنتظر من يصغي إليها.
في أعمالي الأربعة -من الصريم إلى فيلق الإبل- سعيت إلى إعادة اكتشاف الإنسان في بيئته السعودية والعربية الخاصة، بوصفه جزءاً من التجربة الإنسانية الكبرى.
فما يعيشه البدوي في الصحراء، أو القروي بين واحات النخيل، أو ابن المدينة في أزقتها القديمة، يرتبط في جوهره بما يعيشه البشر جميعاً: الحب، الفقد، الذاكرة، القلق، الطموح، والبحث عن المعنى.
أنا أكتب عن الإنسان بمشاعره ولغته ولهجته وظرفه، لأنني أؤمن أن أصدق الأدب هو ما يأتي من أرض الكاتب.
ومن هنا، فإن التجذّر في المحلية ليس انغلاقاً، وإنما شرط للانفتاح الحقيقي. فالأدب الذي ينطلق من بيئة صادقة قادر على أن يصل إلى قارئ في أقصى الأرض؛ لأنه يتحدث بلغة القلب، ويُشبه الناس في أعماقهم.
ولعل التاريخ خير شاهد على هذه المعادلة: ألف ليلة وليلة وكليلة ودمنة انطلقتا من عمق الثقافات العربية والهندية والفارسية، لكنهما تجاوزتا الجغرافيا، وأثّرتا في آداب العالم حتى اليوم.
وهذا ما تؤكده أيضاً دراسات حديثة، مثل ما قالته بياتريس غروندلر: إن الأدب العربي المعاصر يحمل قابلية حقيقية لأن يكون أدباً عالمياً بفضل فرادته وصدقه وأصالته.
لذلك، حين أكتب أبتعد عن تقليد ما هو شائع، وأعود إلى ذاكرتي الأولى، وملامح المكان، ولهجة الأمهات، ووجوه الأجداد، والقصص المنسية في أطراف المدن والقرى.
وأقدّم هذا كله كنص حيّ نابض بالحياة، يستدعي الأسئلة، ويُمتع ويُدهش في آن واحد.
• ما الصعوبات التي تواجهها أثناء كتابتك الروائية؟
•• الصعوبة الكبرى -التي أواجهها دائماً عند الشروع في عمل روائي جديد- هي البحث عن الفكرة الإبداعية الأصيلة التي تستحق أن تُكتب.
وهناك مقولة شهيرة لبنجامين فرانكلين تختصر كثيراً من الحيرة التي تسبق كل مشروع كتابة، يقول فيها:
«إما أن تكتب شيئاً يستحق القراءة، أو تفعل شيئاً يستحق الكتابة».
أؤمن أن الكتابة تعبير عن موقف من الوجود. ولهذا، لا أبدأ الكتابة إلا حين أشعر أن ما سأقوله يُضيء زاوية معتمة في الإنسان، أو في الذاكرة، أو في التجربة الجمعية.
الفكرة لا تأتي بسهولة، فهي بذرة عاطفية وفكرية تحتاج إلى إنضاج ورعاية ذهنية وتأمل وصبر طويل.
ومن الصعوبات أيضاً: إعادة اختراع النفس مع كل رواية.
تخطيط النص وبناء حبكته، ورسم شخصياته المتقلبة، وابتكار لغة تناسب زمان الحكاية ومكانها، واختيار الأسلوب السردي الأمثل للتعبير عن الأحداث والمشاعر، كلها تحديات تفرض على الكاتب أن يكون في حالة تخلي عن يقينياته السابقة، وأن يدخل مغامرة جديدة تشبه العبور بلا خارطة، بكل ما تحمله من ارتباك ومتعة واكتشاف.
وهناك صعوبة أخرى، خفية لكنها شديدة الحضور: الكتابة بوصفها مواجهة مع الذات، مع مخاوفها وذاكرتها وتردداتها، ومع بعض أفكار المجتمع أيضاً. وقد كتبت في إحدى مقالاتي:
«الكتابة الإبداعية هي شريك الوعي ومُستنفر الروح. هي الحب، ونحن نمارسها من أجل البقاء».
فالكتابة تُخرجك من عزلتك، لكنها في الوقت نفسه تُجبرك على تفكيك ذاتك وإعادة تركيبها حرفاً حرفاً. ولهذا، فإن أجمل نصوصي كانت غالباً نتيجة لصراع داخلي طويل، أو حوار ممتد لا يصل إلى نتيجة قاطعة.
ولا يمكن إغفال التحديات الخارجية: الزمن، التشتت، الانشغالات، الضوضاء من حولك، وحتى بعض الإحباطات التي تصل بسبب التعامل مع رواياتك السابقة.
لكن هذه كلها تبقى تفاصيل ثانوية أمام المعركة الحقيقية: «أن تكتب شيئاً يلمس قلب القارئ، ويمنح الحياة معنى جديداً، أو يلبي نداء وجدانياً، أو يطرح سؤالاً عميقاً لم يكن حاضراً من قبل».
• كيف ترى مشهدنا الثقافي اليوم؟
•• أراه في أبهى صوره في عقدنا الأخير، إذ نعيش اليوم نهضة ثقافية حقيقية، على مستوى الإنتاج الأدبي عموماً، وعلى مستوى الوعي والتفاعل والانفتاح.
ما كان يُعدّ في الماضي تمنيات مؤجلة أو حراكاً نخبوياً محدوداً، أصبح اليوم مساحة مجتمعية مفتوحة، تشارك فيها شرائح متعددة من الأجيال والمجالات، من الكاتب والمثقف، إلى القارئ العادي، وحتى الشاب الذي يخطو خطواته الأولى نحو الفن والإبداع.
الانفتاح الثقافي الذي تشهده بلادنا اليوم يقوم على قناعة راسخة وسياسة عامة، تتجه نحو تحوّل عميق في نظرتنا للثقافة، بوصفها جزءاً من الهوية الوطنية، ومن أدوات القوة الناعمة، وصناعة المستقبل.
نشهد توسعاً في معارض الكتب، وازدياد بيوت الثقافة، وتنوعاً في دور النشر، وجرأة في الطرح، وتزايداً في الترجمة، وانتقالاً ملحوظاً من ثقافة الاستهلاك إلى ثقافة الإنتاج والمبادرة والمشاركة.
كما أن استحداث وزارة للثقافة، وهيئة للأدب والنشر والترجمة، وجهات ثقافية أخرى، أحدث فارقاً من خلال مبادرات واعية مثل: الشريك الأدبي، المهرجانات الثقافية، القنوات المتخصصة، الجوائز الوطنية، المعتزلات الأدبية، الحوارات المفتوحة. هذه المسارات منحت للمواهب فرصاً حقيقية للحضور والازدهار، بعيداً عن العلاقات والدوائر المغلقة.
اللافت أيضاً هو الحراك المجتمعي التفاعلي: حضور القرّاء في بيوت الثقافة والجمعيات الأدبية، وتفاعلهم على وسائل التواصل، ونقاشات النقد، والاحتفاء بالكتب الجديدة. كلّها مؤشرات على أن الثقافة أصبحت جزءاً أصيلاً من وعي المجتمع، ولم تعد ترفاً نخبوياً.
وأشعر بتفاؤل كبير، فهذا الحراك يتجه نحو ترسيخ بنية ثقافية مستدامة، تتغذى من الموروث، وتتصل بالعالم، وتنفتح على الإنسان في كل مكان، دون أن تفقد خصوصيتها.
نحن في وثبة نادرة، تتشكل فيها ملامح ثقافة سعودية جديدة، عميقة وجريئة، تحترم تراثها، وتخاطب العالم بلغة الحاضر.
والمسؤولية اليوم مشتركة -بين المؤسسات الرسمية، والمبدعين، والمجتمع- للحفاظ على هذا الزخم، وتوجيهه نحو إنتاج ثقافة تُكتب، وتُقرأ، وتُصنّف، وتبقى.
• حدّثنا عن رأيك في الجوائز الأدبية، وأنت واحد ممن فازت روايته «ابنة ليليت» أخيراً بتحويلها إلى سيناريو؟
•• لا شك عندي أن الجوائز الأدبية من أهم الأدوات الفاعلة في تحفيز الإنتاج، وتكريس الجودة، ورفع سقف التطلعات الإبداعية.
من أهم معايير نجاح الجوائز أن تكون عادلة وشفافة، فذلك يمنح الكاتب حافزاً قوياً، ويُسلّط الضوء على النص، ويدفع به نحو قرّاء جدد، ويفتح أمامه نوافذ جديدة في النقد والقراءة.
الجوائز ظاهرها تتويج، وجوهرها قوة ديناميكية للنمو الثقافي، وتوسيع خارطة التأثير.
ومع التقدير للجهود القائمة من الجهات المعنية برعاية الثقافة، إلا أن المشهد السعودي اليوم يحتاج إلى جائزة وطنية كبرى مخصصة للرواية السعودية، تحمل طابعاً مؤسسياً واضحاً، وتتناسب مع وفرة الإنتاج وتحولاته النوعية.
فنحن أمام قطاع ينتج أكثر من 300 رواية سنوياً، وهذا يستدعي آلية تكريم تحتفي بهذه الطاقة وتعيد تصديرها ثقافياً بما يليق بها.
المشاركات في الجوائز العربية -التي يزيد عددها على 30 جائزة في مختلف المجالات الأدبية- لا تُغني عن الحاجة إلى مظلة داخلية تدعم وتتبنّى التجربة السعودية وفق خصوصيتها وسياقها.
• ماذا عن علاقتك بالناشر طباعةً وتوزيعاً في ظل شكاوى الأدباء من دور النشر؟
•• علاقة الكاتب بالناشر علاقة جوهرية، وهي أحد أركان المشهد الثقافي التي لا تستقيم دونها العملية الإبداعية.
ودور النشر لم تعد شركات طباعة تقليدية، إنما تحوّلت إلى شريك في إيصال الكلمة إلى القارئ، وقد ذُكر اسمها نصاً في تسمية «هيئة الأدب والنشر والترجمة»، باعتبارها جزءاً من النسيج الثقافي الوطني.
ومع ذلك، لا يمكن تجاهل أن هذه العلاقة تعاني من غياب الحوكمة، خصوصاً فيما يتعلق بالعقود المبرمة بين المؤلف ودار النشر.
فلا توجد حتى الآن مرجعية تنظيمية واضحة تُلزم الطرفين ببنود موحدة تحفظ الحقوق، وتصوغ العلاقة بصيغة مهنية متوازنة وعادلة.
هذا الغياب فتح الباب أمام عقود مجحفة، وغموض في الحقوق، وتأخر في التقارير المالية، وضعف في الشفافية حول التوزيع والتسويق، وازدياد حالات سوء الفهم بين الطرفين.
من واقع التجربة، هناك دور نشر جادة تحفظ للكاتب مكانته، وتعتمد الصراحة والوضوح، وتقدّر القيمة الأدبية للنص.
وفي المقابل، هناك من ينظر إلى الكاتب كمورد مالي قبل أن يكون مصدراً للإبداع، ولا يتعامل معه شريكاً ثقافيّاً في المشروع.
هذا التفاوت في مستوى العلاقة سببه الأساس هو غياب إطار ناظم يحدّد الحقوق والواجبات، ويضمن العدالة للطرفين.
من هنا، أجد أن الوقت قد حان لأن تُطلق هيئة الأدب والنشر والترجمة منصّة وطنية للعقود الثقافية، على غرار ما هو معمول به في قطاعات مثل عقود العمل، وعقود الإيجار العقاري، والعقود التجارية الموحّدة.
وجود منصة رسمية تُنظّم العلاقة بين المؤلف والناشر سيكون له أثر مباشر في تقليل الفوضى، وحماية الحقوق، والحدّ من ممارسات الإجحاف التي يعاني منها كثير من الكتّاب والكاتبات، كما يُريح دور النشر من العشوائية والمطالبات المتكررة.
نحن بحاجة إلى بيئة احترافية واضحة تُشجّع الكاتب على الإنتاج، وتُحفّز دور النشر على التميّز، وتجعل من العلاقة بين الطرفين شراكة قائمة على الثقة والتكامل، لا علاقة هشّة تقوم على المجاملة أو الغموض.
• هل استفاد الكاتب الروائي أحمد السماري من التحوّلات الاجتماعية والثقافية في المملكة؟ وكيف؟
•• نعم، وبكثير من الامتنان. لقد استفدت من هذه التحوّلات إنسانياً أولاً، ثم فكرياً وإبداعياً.
المجتمع السعودي اليوم يعيش مرحلة تحول غير مسبوقة، شملت تفاصيل الحياة اليومية، وأنماط العلاقات، وحدود التفاعل بين الناس. وبالنسبة لي كوني كاتباً، فإن هذا الانفتاح حدث كضرورة إنسانية ومجتمعية فرضت نفسها.
بات الجلوس في المقاهي مع الأصدقاء، وتبادل الأحاديث الجادة والعابرة، أمراً معتاداً لا يخضع لحسابات اجتماعية معقدة.
أصبح التواصل مع المرأة -في سياق الثقافة والعمل والحوار- أمراً طبيعياً، بلا ريبة أو تحسّس أو شعور بالذنب كان يخنق المواقف النبيلة ويعكر صفو التعاملات.
هذه التحوّلات كسرت الجليد، وحررت العلاقات من التوجّس والتأويل المفرط، ومنحت الكاتب فرصة نادرة ليصغي ويتأمل ويتفاعل مع واقعه دون أقنعة.
صار الواقع أكثر وضوحاً، والإنسان أكثر حضوراً، والمشهد أكثر ثراءً، والحديث أكثر صدقاً.
وعلى مستوى الكتابة، أثّرت هذه التغيرات في بناء الشخصيات، وفي رسم العلاقات، وفي توسيع أفق الحوار داخل النص. لم أعد مضطراً أن أكتب من وراء ستار، أو أن أستعير رموزاً مبالغاً فيها لأوصل معنى ما أريد.
اللغة أصبحت أكثر جرأة، والحوار أكثر واقعية، والرواية أقرب إلى نبض المجتمع كما هو، لا كما يُتخيّل أو يُخشى.
الرواية تستمد مادتها من نبض الحياة، وتحوّل التفاصيل اليومية إلى أسئلة وجودية وجمالية. وكل تحوّل مجتمعي يُعدّ أداة جديدة في يد الكاتب، ومساحة لإعادة قراءة الذات والواقع بوعي أكثر انفتاحاً وجرأة، خصوصاً عند نقد بعض الرؤى والأفكار التي سيطرت طويلاً على العقول وأخرجت المجتمع من الطبيعي إلى الوصاية.
اليوم أكتب بعيون أكثر انفتاحاً، وبقلب أقلّ تحفظاً، وبلغة تعكس ما نشهده من تصالح جميل بين الذات ومحيطها، وبين الإنسان وصورته الاجتماعية الجديدة.
القرآن كان له أثر كبير في علاقتي بالسرد
«فيلق الإبل» اختبار جديد لتحدي الكتابة
في الكتابة أبتعد عن تقليد الشائع
حياتي المهنية صقلت وعيي
الرواية وسيلة لإهداء السعادة للآخرين
أخبار ذات صلة
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عكاظ ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عكاظ ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.