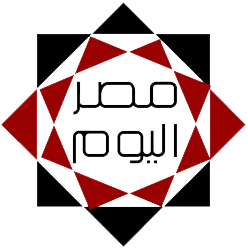وهذا الديوان (تجاوزاً) نوع من الشعر الخالص في الحب، عبّر عنه الشاعر في شهريات «تُلبي كلما لا أنادي؛ أجيبُ حينما لا تسأل»، وما بين (كلما وحينما) مبتدأ العلاقة ما بين (هو) و(هي) التي انطلق منها إلى التحرُّر من القيد الشعري، ذلك القيد الاختياري الذي يجد الشاعر نفسه يعود إلى القصيدة مختاراً وراغباً بوصفها الملاذ الأخير، فالرسائل، والهوامش، والقصائد الحرة كلها محاولات للابتعاد عن القصيدة/ المتن، ولكنها في النهاية تعيد القصيدة إنتاج ذاتها كمرجعية لا مفر عنها ومنها. ومنذ الإهداء «إلى أول من علمنا فقه الحب، ابن حزم الأندلسي»، والذي توسل به وبمقولاته في رأس كل قصيدة، فجاء استدعاء ابن حزم؛ ليمنح التجربة شرعية مزدوجة: من جهة هو تأصيل ثقافي للحب كموضوع عريق في الأدب العربي، ومن جهة أخرى هو تبرير ضمني لأي تجريب لاحق، وكأن الشاعر يعود للتراث، ويعيد صياغته، بل ويسرّب ما يريد من قصص ومواقف وكلمات أجنبية، واستحضار مدينته (الجبيل)، وكأنه يستعيد كل ذلك ويعود إليه، وكما جاء من القصيدة وعاد إليها؛ لتصبح القصيدة المتن الذي لا يفرّط فيه الشاعر، والمرجعية التي لا يمكن الفكاك منها مهما حاول البحث عن أشكال أخرى، وليكون هذا الرسم الهندسي للديوان شافعاً لتوصيفه «مهندس كما تشهد الجامعة، وشاعر كما يقولون»، فجاء الديوان منطلقاً وفق هيكل هندسي، يبدأ بمقولة الوشّاء «وقد عشق كل العرب، بل أكثرهم قد عشق» التي لم تأتِ مجرد تحية فحسب، بل عتبة لا تنتهي، وقد شفّعها بالحمامة التي شبّت عن الطوق في الإهداء، والتي تمثل جسراً ثقافياً يربط الشاعر بأصل تراثي راسخ، وبرموز الحب في تاريخنا العربي المديد، ولعل (تيم) يضاف لقائمتهم، والعجيب أنه لم يأتِ اسم (تيم) إلا في عنوان الكتاب، وغلافه الأخير، ولو توارى فما هو إلا (هو)، وما هي إلا (هي) والقصيدة التي قادته إلى ما استطاع التعبير عنه وتسميتها:
«أسمّيكِ القصيدة في تمرُدها على الشكل».
وهذا ما ساقه إلى المتن والهامش، إذ جعل القصيدة العمودية المتن، أي الأصل الذي ينطلق منه، بينما تمثل قصيدة التفعيلة والنصوص الحرة الهامش، أي المساحة التي يهرب إليها ليجد حرية أكبر. غير أن المفارقة تكمن في أن الهامش عند عبداللطيف بن يوسف ليس تابعاً أو أقل قيمة؛ بل كثيراً ما يضيء ما يعجز المتن عن قوله، ففي بعض النصوص نجد أن ما يُكتب في الهوامش أو في الرسائل أكثر حيوية وصدقاً، وذلك حين «حاولت القصائد وسعها من الأُلفة، واتساعها من.. الأُلَّاف» كما جاء في الإهداء الذي يُعدُّ بوصلة تهدي القارئ إلى شمال الكتاب دوماً.
ولا تزال الرسائل، وإن اختلفت صورها، حمام العشاق، وسبيل وصالهم، وهكذا جاءت في الديوان، إذ يتوسل بها الشاعر للهروب من القيود الشكلية للقصيدة، فالرسائل تسمح له بالجمع بين السرد، والبوح، والشعر في آن واحد.
وهذا المهرب (إن جاز لنا القول بذلك) ليس خالياً من الشعر؛ إذ نجد أن الشاعر يصرّ دائماً على ختم رسائله بقصيدة، سواء في رسائله أو في رسائلها. كأن القصيدة تفرض حضورها رغماً عنه، أو كأنها القاسم المشترك الذي لا يكتمل الخطاب العاطفي إلا به.
من هذا المنطلق الذي يجعل القصيدة شمالاً دوماً؛ تصبح الرسائل ممراً للقصيدة أكثر من كونها بديلاً عنها، فالرسائل ما هي إلا شكل يسمح بالهروب المؤقت، غير أن العودة إلى القصيدة تظل حتمية، وكأنها تحفظ للشاعر نرجسيته التي لا تجعله يتنازل عن الشعر حتى على لسان محبوبته، فهي لا تقل لغة وبلاغة عمّا يضعه في رسائله، وكأن نرجسية الشاعر لا تتنازل عن التولّه إلا بمن يشبهه، فهو يصرّح «كم تشبهينني يا بنت..»، ولعلها الوسيلة التي تجيز للشاعر توحد اللغة في كل الكتاب، وقربها حتى في رسائلها، وقول الشاعر سالف الذكر؛ يتحول إلى مفتاح قرائي، فالمحبوبة ليست (آخر) مستقلاً في النص، بل انعكاس للذات الشاعرة، وهي بذلك آلية فنية تجعل الحب تجربة تمركز الذات حول نفسها، فالحبيبة تُستحضر لتأكيد صورة الشاعر، لا لذاتها، بل لتعيدنا كرّة أخرى إلى فكرة هي/ القصيدة مرآة الأنا؛ فالهروب منها مستحيل لأنها تحمل صورته التي لا يطيق الانفصال عنها، وكذلك القصيدة التي لا مهرب منها وعنها.
أخلص عبداللطيف بن يوسف للقصيدة حتى في مهربه، فلم يكن كغيره من الشعراء الذين هربوا إلى حضن الرواية الفسيح، محمّلين بلغتهم الشعرية التي تعرقل السرد دوماً، غير أنه، على العكس من ذلك، تربّع في مساحة لا يستطيع أحد أن يحاججه عليها، حين اختار الرسائل الأدبية في لباس روائي ختمه بصوت الراوي في شهر ديسمبر، فكل ما في الكتاب مجموعة من الأحداث على هيئة رسائل، والرسائل لها القدرة على استيعاب: الشعر، السرد، والاعترافات، والتعريفات، والتأملات، وليمرر في هذا القالب حتى الشعر النبطي لغيره «قل للقلوب اللي تبي مننا نور.. خلاص طارت بالبياض الحمامة»، وليجعل في الختام سبعة هوامش بعد الفراق في صورة المتن، ويضع الهامش صراحة ليس متناً فحسب؛ بل «معلقات على مشانق الأيام»، مخلصاً للقصيدة، والقصيدة وحدها، مختاراً العدد سبعة، وما يرمز إليه من الكمال والتمام والنماء، كل في ذلك في «سنة حب كاملة» ليضعنا أمام تساؤلات يجيب عليها الكتاب: كيف نغادر القصيدة دون أن نتخلى عنها؟ وكيف نحيا في الهامش بينما لا نستطيع الاستغناء عن المتن؟ وكيف للهامش أن ينازع المتن، ويصله في نهاية المطاف، كل ذلك يجمعه تيم في سنة حب كاملة، حين تكون القصيدة الرباط الأوثق، بين العاشق ومعشوقته، بين الذات والآخر، بين الماضي والحاضر.
أخبار ذات صلة
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عكاظ ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عكاظ ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.