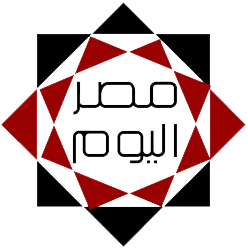[email protected]
لا يمكن النظر إلى حال الثقافة مثلما النظر إلى حال السياسة. الثقافة أوسع وأشمل وارتباطها بالناس والجماعات أرتباط قائم على الحياة اليومية بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى : اللقاءات والحوارات المقصودة وغير المقصودة في الأماكن المغلقة والمفتوحة ، المناسبات الاجتماعية والثقافية القائمة على سلوك العادات والتقاليد والطقوس الرمزية الموروثة، والعلاقات بين البشر التي ليس لها حدود جغرافي ولا سقف تاريخي معين في تأثيرها الثقافي والإنساني والفكري. جميع هذه الحالات تمثل طبيعة الثقافة بوصفها معطى أنتروبولوجي ، وهي بالتالي تمتاز بالمرونة في تنقلها من مجتمع إلى آخر، وتمتاز بالأسبقية في التموضع في السلوك والتربية والتصور على كل حدث سياسي مؤثر . وهذا ما تخبرنا عنه تجارب الأمم في مسيرتها الحضارية.
بينما حال السياسة كما هو معروف مرتبط بالمصالح وتحقيق المكاسب، لذلك تاريخها تاريخ صراع وحروب وفتن، ولا يخلو تاريخ من تاريخ الأمم، مهما كان سلوكها السياسي أو مهما كانت قيمها السياسية من اقتتال . صحيح هناك فرق بين نظام وآخر، إلا أن الحد الأدنى من الممارسة السياسية يثير النزاعات والحروب.
هذا التناقض الصارخ بين الحالتين: الثقافي والسياسي لا تظهر أو تبين أكثر بين المجتمعات كاضطراب في الرؤية وسوء فهم في المواقف والمقاربات ، إلا إذا وضعناها تحت مجهر العلاقة القائمة بين الثقافة العربية والغرب السياسي.
حين عمّت الحداثة الأوروبية العالم العربي وأوجدت بالتأثير ما يسمى بالإصلاحات، والحماس منقطع النظير عند النخب والمثقفين، للقيم التي تبنتها الثورة الفرنسية، يسبقها في ذلك تداعيات حملة نابليون على مصر 1798 م وما تركته من أثر بالغ على الحياة السياسية والثقافية. لكن ماذا عن الجانب الاستعماري الذي دشنته فرنسا؟ باحتلالها منذ ثلاثينات القرن التاسع عشر الجزائر ثم لا حقا تونس ثم على المغرب ثم احتلت سوريا ولبنان بعد الحرب العالمية الأولى . ثم احتلت بريطانيا مصر والعراق ضمن خطة سايس بيكو للتقسيم وإعطاء فلسطين للإسرائليين.
هذا الوجه الاستعماري الذي كشف عن أطماع الدول الكبرى واستغلال قوتها في السيطرة على مقدرات العالم العربي لا يخفي حقيقة الحراك الثقافي التنويري الذي هيمن على الخطاب العربي في شتى مجالاته المختلفة منذ رفاعة الطهطاوي في القرن التاسع عشر إلى طه حسين في النصف الأول من القرن العشرين ، وذلك بالتزامن مع هذا الوجه الاستعماري البشع.
بعض المؤرخين يسميها حقبة عصر النهضة والبعض الآخر يسميها الحقبة الليبرالية ، وهذه لها دلالتها الكبرى على قيم الحداثة الإوروبية كانت سريعة الانتشار رغم طغيان سياسة الاستعمار الذي ولّد مقاومة وثورات . علل البعض حماس المثقفين في تلك الحقبة على تبني بعض هذه القيم كالحرية وإصلاح الدين وحرية المرأة والمعرفة العلمية وتطوير مؤسسات الدولة على أن هؤلاء المثقفين لم يعيشوا حياة مزدوجة أو انفصالية بين ما يؤمن به المجتمع ويعتقده وبين معتقداته ، أي أن اختلاف التيارات الفكرية بين ما كان يسمى علماني وذاك إسلامي لم تكن سوى تسميات لا تمس واقع هؤلاء وحياتهم بصلة " لقد كان – كما يقول حازم صاغيه في كتابه ( في أحوالنا وأحوال سوانا ) أحمد السيد ممن تتلمذوا على الشيخ محمد عبده كما لازم جمال الدين الأفغاني في إسطنبول، وبعده درس طه حسين وأحمد أمين في الأزهر" .
لكن هذه التسميات تحولت لا حقا بعد هيمنة العسكر على الحكم في البلاد العربية منذ ١٩٥٢م في مصر إلى واقع يحتل مفاصل الحياة الاجتماعية والثقافية والدينية ، وأصبح السياسي يهيمن على مظاهر الثقافة ومجالاتها المختلفة بعدما كان المثقف في تلك الحقبة مؤثرا سياسيا ومجتمعيا .
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.