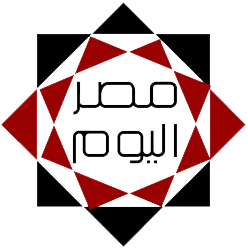تحقيق: سارة البلوشي
أصبحنا في زمن تحوّلت فيه الكلمة إلى سهم، والتفاعل إلى سلاحٍ يجرح من دون إحساس، وكل كلمة نُطلقها تحمل أثراً، وقد تكون سبباً في بناء مشاعر الشخص، خلف الشاشة والفضاء المفتوح أو هدمها، هذا الفضاء الذي يحدد بالكلمة من نحن.
فإن القول الطيب يعبّر عن تربية وقيم وأخلاق، بينما القول الهابط يجحد الاحترام، مهما حصد من إعجابات أو تصفيق زائف. وبهذا التحقيق، نضيء على ثقافة الردود في العالم الرقمي، ونتساءل: إلى أين تقودنا هذه الردود المستفزة؟ وكيف يمكن توجيه المراهقين إلى المسار الصحيح وعدم التأثر بذلك؟ وهل دائماً تكون الإجراءات القانونية مصيرهم.
توضيحاً للموقف القانوني حول هذا الموضوع، قال المحامي عبدالله بن حاتم: بين حرية التعبير وحدود الإساءة، تبقى المسافة دقيقة، وقد تتحول إلى أداة استغلال قانوني في بعض الحالات، وهنا تبرز الحاجة لتوازن تشريعي، ووعي مجتمعي، وممارسات منصات أكثر مسؤولية.
وأكد أنه يحق لأي شخص طبيعي أو اعتباري رفع دعوى إذا رأى أن هناك إساءة أو قذفاً أو تهديداً أو تشهيراً موجهاً إليه، عبر تعليق أو منشور، وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية يغطي هذا النوع من الإساءة.
الإثبات
وأوضح أن الإثبات يكون عن طريق جمع الأدلة الرقمية، خلال نسخ من التعليقات، توثيق بالتاريخ والوقت، وأحياناً بموجب محضر رسمي من الجهات المختصة أو محضر توثيق إلكتروني معتمد.
وأما الإجراءات، فتبدأ غالباً بتقديم بلاغ للجهة المختصة (مثل الشرطة الإلكترونية)، ثم تحويل القضية إلى النيابة العامة، ومن ثم للمحكمة. وتستدعى الأطراف، ويتم التحقيق.
وأشار بن حاتم إلى أن هناك نقطة مثيرة لمعرفة ما إذا كان هناك اختلاف في المسؤولية القانونية، إذا كان المنشور نفسه مستفزاً أو ينطوي على تحريض، وبين إذا كان المنشور يتضمن تحريضاً متعمداً أو استفزازاً واضحاً أو خطاب كراهية، فقد يؤخذ ذلك في الحسبان لكن لا يُبرر ذلك التجاوز في التعليق؛ والقانون لا يسقط الحق في الشكوى، لكنه قد يخفف العقوبة عن المعلق أو يلغيها إذا ثبت أن الرد كان في إطار الدفاع أو الرد الطبيعي.
استفزاز الجمهور
ولكثرة انتشار ظاهرة استخدام القانون للتكسّب من تعليقات الجمهور بين بعض الفئات، أوضح إذا ثبت أن صاحب المنشور تعمد استفزاز الجمهور لاستدراج ردود ثم رفع قضايا لتحقيق مكاسب مادية، فإننا أمام حالة واضحة من «إساءة استخدام الحق القانوني». والقانون يُمنح لحماية الأشخاص، لا للابتزاز أو الاصطياد في الماء العكر.
وقال عبدالله بن حاتم: إن المنصات لها مسؤولية «تنظيمية» عبر سياساتها الداخلية، مثل حظر المحتوى المسيء أو التحريضي، وتوفير أدوات الإبلاغ. لكن من الناحية القانونية، أغلب المنصات لا تتحمل مسؤولية مباشرة عن تعليقات المستخدمين، بل تُحمّل الفرد المسؤولية.
بيئة سامة
وبينت الدكتورة عائشة الجناحي، أن البيئات الإلكترونية تؤثر تأثيراً عميقاً في نفسيات المراهقين والأطفال لأسباب عدة، أولها تطبيع العنف اللفظي والحدة، فعندما يعتاد الطفل أو المراهق على مشاهدة الردود العدوانية أو الساخرة، فإن هذا السلوك قد يطبع في ذهنه، ومن ثم يؤمن أن الحدة والسخرية أدوات مسموحة للتفاعل، ما يُضعف لديه مفاهيم التعاطف والحوار المتزن مع الآخرين.
كما أن المنشورات المستفزة تخلق بيئة رقمية سامة، وقد تجعل الطفل يشعر بأن العالم مكان عدائي أو غير آمن، ما يزيد مستويات القلق الاجتماعي والانطواء لديه، ومن هنا نستنتج إذاً البيئات المستفزة في مواقع التواصل لا تؤثر في طريقة تفكير المراهق والطفل فقط، بل قد تُربك نموهم النفسي والعاطفي، وتؤدي إلى آثار طويلة الأمد في السلوك والانتماء والثقة بالنفس.
خلق اضطرابات
وقالت د.عائشة الجناحي: إن الردود السلبية والتنمر الإلكتروني يمكن أن تؤدي مباشرة إلى اضطرابات نفسية خطرة، خاصة لدى الأطفال والمراهقين بحكم خبرتهم الخفيفة في الحياة ومرحلتهم العمرية.
وأوضحت أن آثارها لم تعد مجرد تجاوزات لفظية، بل تحوّلت إلى عوامل ضغط نفسي هائل تؤدي إلى اضطرابات حقيقية مثل القلق، الاكتئاب، وانخفاض احترام الذات، خصوصاً لدى المراهقين. فهذه البيئة الرقمية السلبية قد تزرع الخوف من التفاعل، وتربك نموهم النفسي والاجتماعي، ما يستدعي تدخلاً واعياً من الأسرة والمؤسسات المعنية لتضع سياسات حازمة لحمايتهم وتعزيز صحتهم النفسية.
التغيرات السلوكية
وعلى الأهل أن ينتبهوا إلى مجموعة من التغيرات السلوكية والنفسية التي قد تشير إلى تأثر الطفل بتجربة مؤذية عبر صفحات الإنترنت، وأبرزها العزوف عن التفاعل مع الأسرة أو الأصدقاء، أو التهرب من الأنشطة التي كان يستمتع بها في السابق، أو التعرض إلى نوبات غضب مفاجئة، أو حزن غير مبرر أو بكاء متكرر من دون أي سبب واضح، وقد يلاحظ تراجع في المستوى الدراسي بسبب صعوبة كبيرة في التركيز أو فقدان الحافز للقيام بالواجبات المدرسية.
فضلاً عن خوف أو تردد من استخدام الهاتف أو الإنترنت بعد أن كان متعلقاً بهما كثيراً.
غرس الثقة
وأكدت د.عائشة الجناحي، أن تعزيز مناعة الطفل النفسية يبدأ أولاً من الأسرة، عبر غرس الثقة بالنفس منذ المراحل العمرية المبكرة، وتعليمه التمييز بين النقد البنّاء والإساءات المتعمّدة، وتشجيعه على التعبير عن مشاعره بحرية وثقة من دون أي خوف أو تردد.
كما أن الحوار المفتوح في الاستخدام الواعي للتواصل الرقمي، وتوفير بيئة أسرية آمنة وداعمة، يسهمان بلا شك بشكل كبير في بناء توازن نفسي يحميه من التأثر السلبي ويعزز من وعيه الرقمي.
التوعية
وأشارت إلى أن للحملات التوعوية دوراً استباقياً لا غنى عنه في تحصين الأفراد، لاسيما اليافعين، من آثار المحتوى الرقمي السلبي والتنمر الإلكتروني. فهي لا تكتفي بنشر المعرفة، بل تخلق بيئة ثقافية تعيد تعريف العلاقة بين المستخدم والمنصة الإلكترونية، وتزرع الوعي بالحقوق الرقمية وحدود التفاعل الأخلاقي في هذه المنصات الرقمية.
كما تسهم في إشراك الأسرة والمدرسة مكوّنات رئيسية في منظومة الوقاية والدعم، وتعزز مهارات الرفض الواعي وضبط التفاعل والسلوك وتقدير الذات، ما يساعد النشء على تجنّب التبعية السلوكية والتأثر العاطفي الحاد تجاه المضامين المستفزة.
زمن التفاعل
وشددت د. صابرين الفقي، على أنها لا تؤيد السماح المطلق للأطفال باستخدام هذه التطبيقات من دون رقابة، مثل «تيك توك» و«إنستغرام»، لأن الخوارزميات في هذه المنصات مصمّمة لجذب الانتباه وزيادة زمن التفاعل، وغالباً ما تدفع بالمحتوى المثير للجدل أو العاطفي لتحقيق ذلك. هذا قد يؤدي إلى تعريض الأطفال لمضامين غير مناسبة أو مؤذية نفسياً. إن لم يكن هناك وعي ومتابعة، فإن هذه التطبيقات قد تتحول إلى بيئة ضارة لنموهم.
وأكدت أن هناك الكثير من المؤشرات التي ينبغي أن ينتبه لها الأهل، مثل الانعزال المفاجئ أو فقدان الرغبة في التفاعل مع الآخرين، وتقلبات مزاجية حادة أو ظهور سلوك عدواني، وانخفاض التحصيل الدراسي أو مشكلات في النوم، والتعلق المبالغ بالجهاز أو الخوف من فقدان الاتصال.
أدوات التعامل
وقالت: إن للحملات التوعوية دوراً بالغ الأهمية، فهي لا تكتفي بنقل المعرفة فقط، بل تخلق وعياً مجتمعياً عاماً أيضاً. عندما تكون هذه الحملات موجهة بطريقة مبتكرة وتفاعلية، فإنها تساعد الأهل، والمعلمين، وحتى الأطفال أنفسهم، على اكتساب أدوات للتعامل مع العالم الرقمي بأمن وسلام. كما يمكن أن تكون وسيلة ضغط على المنصات الرقمية نفسها لتتحمل مسؤوليتها الأخلاقية تجاه المحتوى المنتشر وسلوك المستخدمين.
سلاح ذو حدين
وقالت الأم فاطمة محمد الحمادي:، إن مواقع التواصل سلاح ذات حدين، وعلينا نحن أولياء الأمور أن ندرك أن دورنا الكبير هو تثقيف أبنائنا بأهمية رفع جانب الاستخدام الإيجابي لهذه المواقع، ولكن من أبرز التحديات التي تواجه استخدامنا لهذا العالم الرقمي اختلاف القيم بين مستخدميه وانفتاح العوالم بعضها على بعض ما أدى إلى تضارب مفاهيم القيم واختلال توازنها عند بعض المستخدمين خاصة الصغار أو الذين لم يتأسسوا التأسيس الصحيح في غرس القيم.
وأوضحت أن على أولياء الأمور الدراية والوعي والنضج للقيام بدورهم في توعية الأبناء التوعية الشاملة عن الطرق المثلى في التعامل مع هذه الوسائل مثل تعرضهم للانتقادات المسيئة أو الاستفزاز في الردود، فعليهم أن يتصرفوا بحكمة ويدركوا أن ما يكتب توثيق ودليل، فليكن الدليل دليل حسن تربية ورقي أسلوب، وليس دليل إدانة أو خيطاً في جريمة إلكترونية. لذلك كانت الضوابط العمرية في التسجيل لهذه المنصات من مصلحة الأبناء وجميع مستخدمي هذه المواقع.
الإشراف والمتابعة
أوضحت د. صابرين الفقي، أخصائية نفسية ومديرة مركز «رؤية» للتدريب على العلوم السلوكية، أنه في ظل تزايد القضايا القانونية التي ترفعها بعض مواقع التواصل، بدعوى الإساءة أو الردود الحادة على محتوى مستفز، يصبح من الضروري إعادة النظر في علاقتنا بهذه المنصات، خاصة حين يتعلق الأمر بالأطفال والمراهقين.ومن وجهة نظري، لا ينبغي السماح باستخدام مواقع التواصل قبل سن 13 عاماً على أقل تقدير، وهي السن التي تتبناها معظم المنصات رسمياً. لكن حتى بعد هذه السن، يجب أن يخضع الاستخدام لإشراف الأهل. فالجانب النفسي والمعرفي للأطفال في هذا العمر لا يزال قيد التشكّل، ولا يمكنهم دائماً التمييز بين السخرية، التنمر، أو الحقيقة من الزيف.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.