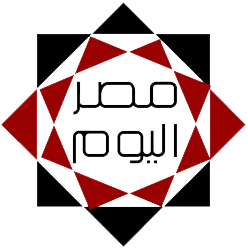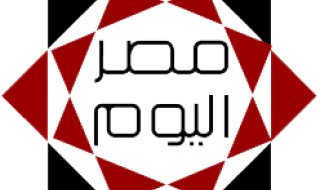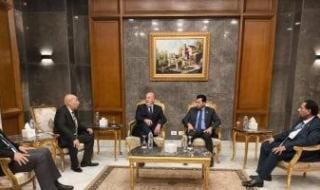في ظل التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة ضمن رؤية 2030، يبرز الاهتمام بالمواقع التراثية كركيزة مهمة من ركائز التنمية الثقافية والسياحية، وتحفل المملكة بالعديد من البلدات والقرى التاريخية، التي تعكس التوازن بين الحاضر والماضي، والطموح والموروث.
ويأتي اليوم العالمي للتراث (18 أبريل) ليذكّرنا بأهمية هذه المواقع، ليس فقط كمعالم تاريخية، بل كمصادر للهوية والانتماء ومفاتيح لفهم ماضينا، وأثبتت المملكة ريادتها في صون التراث، من خلال تسجيل مواقع متعددة لدى اليونسكو، وتطوير مشاريع حماية وإحياء للمعالم الأثرية.
كان سور جدة، الذي أُزيل عام 1947، يحتوي أبوابًا عديدة، مثل باب مكة، وباب المدينة، وباب المغاربة، وغيرها.
واستُخدم حجر الكاشور الجيري المرجاني كمادة أساسية لبناء المنطقة، بالإضافة إلى الحجارة المجلوبة من الجبال القريبة من جدة.
كما كانت البيوت فيها تتكون من عدة طوابق، وجرت العادة أن يكون الطابق الأرضي مخصصًا للضيوف واستقبالهم، في حين خُصصت الطوابق العلوية لأهل البيت.
وتميزت تصاميم البيوت بالرواشن التي تغطي مساحات كبيرة من واجهاتها، وكانت الرواشن تزيد وتنقص في كل بيت بناءً على الحالة الاقتصادية لأهله.
وظل نمط البناء التقليدي ساريًا في جدة حتى بدأ آل زينل في تشييد دارهم التي استخدم في بنائها الإسمنت والحديد المسلح.

كانت الخبراء بلدة رئيسة في شمال بلاد القصيم، ومنطقة زراعية مهمة، إذ يعمل غالبية سكانها بالزراعة ورعي الإبل.
ومن أشهر محاصيلها التمر والفاكهة، والحبوب، وتُروى هذه المزروعات من آبار سطحية يبلغ متوسط عمقها 50 قدمًا عُرفت باسم "الخبراء".
تُعد قرية القصار منتجعًا صيفيًا لأهل فرسان، إذ كان الأهالي ينتقلون إليها على ظهور الجمال، ليقضوا فيها 3 أشهر بعد موسم صيد الحريد في أواخر شهر أبريل، ليبدأ حينها موسم يدعى "العاصف"، وهي ريح شماليّة صيفية.
كما تمتاز القرية أيضًا بوفرة المياه الجوفية والعذبة، وتتكون من عدد من الحارات، كل حارة تحتوي على عدد من المنازل الحجرية، وكانت مساحة البيوت لا تتجاوز 5*4 أمتار مربعة.

وفي المجمل تضم القرية نحو 400 بيت بُنيت جدرانها من الحجارة، في حين أن الأسقف استُخدمت في بنائها جذوع النخيل وجريدها، أو شجر الدوم، أو عيدان المض، وتوضع فوقها الخبان، وهي كتل من الطحالب البحرية، ثم يوضع التراب فوقها، وكل ذلك بهدف تأمين المنازل من مياه الأمطار.
تلتف المباني حول ميدان رئيس ومستطيل الشكل، ويقع في غربه المسجد الجامع، أما شرقه فيحتوي على مجموعة محلات تجارية وخدمات عامة مثل: مخازن الغلال، الميزان، النعوش، مكان إيواء الشوارد، بيت الغرباء، والكتاتيب.
وأما الأحياء السكنية فهي ترتبط مع الميدان عبر طرق شريانية؛ كما تتميز البلدة بتعدد معالمها ومواقعها التراثية، ومن أبرزها: السوق أو المجلس، والأسوار والبوابات، ومسجد الفيلقية، والمسجد الشمالي، والمسجد الجامع، وبيت الوهيبي، والآبار القديمة.
واستُخدم الطين (اللبن) في تشييد المباني بالقرية التراثية، كما أن المباني ترتكز على أساسات من الحجر الجيري، أو أي نوع آخر من الحجارة الموجودة بشكل طبيعي في المنطقة.

وتتكون الأساسات من 5 مداميك، ويمكن أن تُشيد المباني الصغيرة على الأرض مباشرةً دون أساسات، أما الأسقف فقد استُخدمت في بنائها جذوع الأثل والنخيل، وتفرش عليها حصائر من السعف وتغطى بطبقة طينية.
وارتكزت أسقف المباني السكنية على أعمدة خشبية، في حين أن المباني الكبيرة والمساجد استخدمت أعمدة أسطوانية من الحجر ومغطاة بطبقة من الجص أو الملاط.
واهتم الملك عبد العزيز آل سعود - طيب الله ثراه- بميناء العقير لكونه البوابة الاقتصادية للدولة السعودية الناشئة، وكان إلى عهد قريب قبيل تأسيس ميناء الدمام الميناء الرئيس الذي يفد إليه الزائرون لوسط الجزيرة العربية وشرقها.
ويعد العقير بوابة نجد البحرية ومعبر الاستيطان في المنطقة وقد استمر أثره السياسي والتجاري والعسكري والفكري واضحًا في الأدوار السياسية التي تعاقبت على الساحل الشرقي للجزيرة العربية، ويعود عمق أقدم تبادل تجاري عبر العقير والبلاد المجاورة لها إلى العصور الحجرية.
وتبين من فحص الأدوات الحجرية التي عثر عليها في هجر، أنها تتكون من أحجار لا توجد أصلًا في مكونات سطحها، مثل الأحجار البركانية وأحجار الكوارتز وأنواع أخرى من الأحجار المختلفة، وإنما استوردت من المناطق الغربية من الجزيرة العربية بعد فحصها من قبل علماء الآثار.
وتدل المواقع والشواهد الأثرية المكتشفة في المنطقة على ما كانت تلعبه العقير من دور مهم في التاريخ القديم، وقد عرضت معثورات من مواقع العقير والجرهاء ترجع إلى عصر الجرهاء في الفترة من 500 إلى 400 قبل الميلاد.
إضافة إلى عرض خرائط تبين الطرق التجارية البرية والبحرية في الجزيرة العربية وما حولها.
وتشير معظم المصادر والمراجع التاريخية إلى أن المنطقة سكنها الكنعانيون منذ نحو 3 آلاف سنة قبل الميلاد، ومن بعدهم جاء الفينيقيون ثم الكلدانيون.
ويأتي اليوم العالمي للتراث (18 أبريل) ليذكّرنا بأهمية هذه المواقع، ليس فقط كمعالم تاريخية، بل كمصادر للهوية والانتماء ومفاتيح لفهم ماضينا، وأثبتت المملكة ريادتها في صون التراث، من خلال تسجيل مواقع متعددة لدى اليونسكو، وتطوير مشاريع حماية وإحياء للمعالم الأثرية.
جدة التاريخية
تحتفظ منطقة جدة التاريخية بالطابع التقليدي للعمارة، الذي يُعد مزيجًا متناغمًا بين المناخ والتقاليد الاجتماعية للسكان.كان سور جدة، الذي أُزيل عام 1947، يحتوي أبوابًا عديدة، مثل باب مكة، وباب المدينة، وباب المغاربة، وغيرها.
واستُخدم حجر الكاشور الجيري المرجاني كمادة أساسية لبناء المنطقة، بالإضافة إلى الحجارة المجلوبة من الجبال القريبة من جدة.
كما كانت البيوت فيها تتكون من عدة طوابق، وجرت العادة أن يكون الطابق الأرضي مخصصًا للضيوف واستقبالهم، في حين خُصصت الطوابق العلوية لأهل البيت.
وتميزت تصاميم البيوت بالرواشن التي تغطي مساحات كبيرة من واجهاتها، وكانت الرواشن تزيد وتنقص في كل بيت بناءً على الحالة الاقتصادية لأهله.
وظل نمط البناء التقليدي ساريًا في جدة حتى بدأ آل زينل في تشييد دارهم التي استخدم في بنائها الإسمنت والحديد المسلح.

قرية الخبراء التراثية
تُعد البلدة التراثية في الخبراء، أحد أهم المواقع التراثية على مستوى محافظة رياض الخبراء ومنطقة القصيم بشكل عام.كانت الخبراء بلدة رئيسة في شمال بلاد القصيم، ومنطقة زراعية مهمة، إذ يعمل غالبية سكانها بالزراعة ورعي الإبل.
ومن أشهر محاصيلها التمر والفاكهة، والحبوب، وتُروى هذه المزروعات من آبار سطحية يبلغ متوسط عمقها 50 قدمًا عُرفت باسم "الخبراء".
قرية القصار
"القصار" قرية تراثية بُنيت من الحجارة وجريد النخل، وهي تقع في جزر فرسان جنوب المملكة العربية السعودية، وتُعد أكبر واحة نخل في مجموعة الجزر.تُعد قرية القصار منتجعًا صيفيًا لأهل فرسان، إذ كان الأهالي ينتقلون إليها على ظهور الجمال، ليقضوا فيها 3 أشهر بعد موسم صيد الحريد في أواخر شهر أبريل، ليبدأ حينها موسم يدعى "العاصف"، وهي ريح شماليّة صيفية.
كما تمتاز القرية أيضًا بوفرة المياه الجوفية والعذبة، وتتكون من عدد من الحارات، كل حارة تحتوي على عدد من المنازل الحجرية، وكانت مساحة البيوت لا تتجاوز 5*4 أمتار مربعة.

وفي المجمل تضم القرية نحو 400 بيت بُنيت جدرانها من الحجارة، في حين أن الأسقف استُخدمت في بنائها جذوع النخيل وجريدها، أو شجر الدوم، أو عيدان المض، وتوضع فوقها الخبان، وهي كتل من الطحالب البحرية، ثم يوضع التراب فوقها، وكل ذلك بهدف تأمين المنازل من مياه الأمطار.
أشيقر التراثية
تقع بلدة أشيقر التراثية في محافظة شقراء التي تبعد 200 كيلومترًا غرب مدينة الرياض، وتمتاز باحتوائها على مجموعة من المباني التراثية المميزة.تلتف المباني حول ميدان رئيس ومستطيل الشكل، ويقع في غربه المسجد الجامع، أما شرقه فيحتوي على مجموعة محلات تجارية وخدمات عامة مثل: مخازن الغلال، الميزان، النعوش، مكان إيواء الشوارد، بيت الغرباء، والكتاتيب.
وأما الأحياء السكنية فهي ترتبط مع الميدان عبر طرق شريانية؛ كما تتميز البلدة بتعدد معالمها ومواقعها التراثية، ومن أبرزها: السوق أو المجلس، والأسوار والبوابات، ومسجد الفيلقية، والمسجد الشمالي، والمسجد الجامع، وبيت الوهيبي، والآبار القديمة.
واستُخدم الطين (اللبن) في تشييد المباني بالقرية التراثية، كما أن المباني ترتكز على أساسات من الحجر الجيري، أو أي نوع آخر من الحجارة الموجودة بشكل طبيعي في المنطقة.

وتتكون الأساسات من 5 مداميك، ويمكن أن تُشيد المباني الصغيرة على الأرض مباشرةً دون أساسات، أما الأسقف فقد استُخدمت في بنائها جذوع الأثل والنخيل، وتفرش عليها حصائر من السعف وتغطى بطبقة طينية.
وارتكزت أسقف المباني السكنية على أعمدة خشبية، في حين أن المباني الكبيرة والمساجد استخدمت أعمدة أسطوانية من الحجر ومغطاة بطبقة من الجص أو الملاط.
ميناء العقير التاريخي
يقع ميناء العقير في الأحساء على ساحل الخليج العربي، ويعد من المواقع التاريخية المهمة في المملكة وأول ميناء بحري فيها، كما كان الميناء الرئيس للحضارات المتعاقبة في الأحساء حتى عهد قريب.واهتم الملك عبد العزيز آل سعود - طيب الله ثراه- بميناء العقير لكونه البوابة الاقتصادية للدولة السعودية الناشئة، وكان إلى عهد قريب قبيل تأسيس ميناء الدمام الميناء الرئيس الذي يفد إليه الزائرون لوسط الجزيرة العربية وشرقها.
ويعد العقير بوابة نجد البحرية ومعبر الاستيطان في المنطقة وقد استمر أثره السياسي والتجاري والعسكري والفكري واضحًا في الأدوار السياسية التي تعاقبت على الساحل الشرقي للجزيرة العربية، ويعود عمق أقدم تبادل تجاري عبر العقير والبلاد المجاورة لها إلى العصور الحجرية.
وتبين من فحص الأدوات الحجرية التي عثر عليها في هجر، أنها تتكون من أحجار لا توجد أصلًا في مكونات سطحها، مثل الأحجار البركانية وأحجار الكوارتز وأنواع أخرى من الأحجار المختلفة، وإنما استوردت من المناطق الغربية من الجزيرة العربية بعد فحصها من قبل علماء الآثار.
وتدل المواقع والشواهد الأثرية المكتشفة في المنطقة على ما كانت تلعبه العقير من دور مهم في التاريخ القديم، وقد عرضت معثورات من مواقع العقير والجرهاء ترجع إلى عصر الجرهاء في الفترة من 500 إلى 400 قبل الميلاد.
إضافة إلى عرض خرائط تبين الطرق التجارية البرية والبحرية في الجزيرة العربية وما حولها.
وتشير معظم المصادر والمراجع التاريخية إلى أن المنطقة سكنها الكنعانيون منذ نحو 3 آلاف سنة قبل الميلاد، ومن بعدهم جاء الفينيقيون ثم الكلدانيون.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.