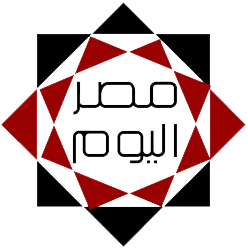- زوربا، نيكولاس كازنتزاكس.
في حين أن الأديب الكبير عبده خال، وبتراكم إنتاجه الروائي البديع، قد عبر القنطرة، بتعبير الخلاص، فإنني أترك القراءة النقدية للمشغولين بهذا الحقل، راغباً أن تكون هذه الورقة شهادة إنسانية، أسجلها عبر معرفتي اللصيقة بعبده، وصداقتنا الممتدة، لأكثر من عقدين، من الزمن، لعل القارئ يعرف شيئاً من جانبه الشخصي الحميم، وعوالمه الخاصة، وذخيرته النفسية المشعة، التي تقف خلف بهاء كلماته!
بمدينة أبها، جنوبي المملكة العربية السعودية، وفي مطلع عام الألفين كنت للتو شاباً صغيراً، أكتب مقالة أسبوعية، في جريدة الوطن، ومن سنوات قليلة قبلها، كنت قد نشرت نصوصاً شعرية، عبر الصحف والمجلات، هنا وهناك، وفي منتديات الإنترنت، التي كانت في بداياتها الصاعدة، في السعودية. كان هذا كل رصيدي حينها، ولم تكن معرفتي بعبده تتجاوز الهاتف، وبالطبع قراءاتي لكل ما كان قد أصدره. عرفت وقتها أن عبده سيأتي لمدينتي أبها، مدعواً لأمسية حوارية، في النادي الأدبي الثقافي. اتصلت به على الفور، وقلت له: «عبده، أرجو ألا ترتبط بأحد عقب الأمسية، سأريك هذه المدينة الصغيرة الساحرة». واتفقنا! وبالمناسبة فأبها واحدة من أجمل المدن الجبلية الريفية، ليس السعودية فقط، بل والعربية أيضاً، تعلو عن سطح البحر بحوالي ثلاثة آلاف قدم، مدينة باردة وممطرة، يغمرها الضباب معظم شهور العام، وقلت في نفسي إنها فرصة لأخذ عبده في جولة معتبرة، وإلى أماكن لا يعرفها غير أبناء المكان. جاء يوم الأمسية، وبالفعل.. حين انتهت اعتذر عبده، من جميع الملتفين عليه، للحفاوة به، وخرجنا معاً، في سيارتي. انطلقنا للطريق الدائري، نسميه (الحزام)، وقلت سأريك بداية (أبوخيال)، وهو مكان آسر، يطل على المدينة، من الجهة الجنوبية الغربية، ومن علوّه يمكنك أن ترى الضباب، وهو يعاود هجومه على المدينة ويغمرها في منظر سريالي أخاذ. انطلقنا.. ثم ماذا؟ لم تمضِ سوى خمس دقائق، وأنا أقود السيارة، وأتحدث لـ(أبي وشل)، فلم يجب! التفت.. فإذا بالرجل بالكاد ينطق، وعلى وشك أن يغيب عن الوعي! وعوضاً عن الجولة انطلقت سريعاً لطوارئ أقرب مستشفى، على الباب حمله الممرضون فوراً إلى أجهزة الإنعاش الأولية، قبل أن ينقلوه بأنبوب التغذية، لأحد الأسرة بقسم الطوارئ؛ كي يبقى تحت الملاحظة. لنقضي تلك الليلة كاملة، في حديث لا أجمل منه، كان عبده يشعر بالخجل. ولا أنسى كلمته، معتذراً، وضاحكاً: «يا عبدالله، معلش.. أنا بقايا حرب وأساطير». حاول بكل ما بوسعه ليقنعني بالعودة لبيتي وعائلتي. كان يحلف أنه بخير، ومعتاد على هذه الهبوطات الصحية المفاجئة، فرفضت، وبقيت معه حتى اقتراب موعد رحلته، إلى جدة، ضحى اليوم التالي. أصر على الخروج، على مسؤوليته، ولا تتوقع أنك تستطيع إقناع عبده، حين يقرر فعل شيء، حتى وهو على سرير المرض. خرج، وأخذته للمطار، وغادر! وحتى اليوم ما زلنا، عبده وأنا، نتذاكر أول لقيا ومعرفة، ونقصها على الصحب، ونضحك. أما الموقف نفسه، أي: انهيار عبده صحياً، فسيتكرر بعد سنوات، في مناسبة أخرى، بظروف مختلفة، وسآتي عليه لاحقاً!
بكل حال.. لعبده تاريخ طويل، منذ طفولته، مع الأمراض، والاقتراب من الموت، حتى الحافة، (بين قوسين: لعل هذا يفسر شيئاً من حالة الموت، الحاضرة دوماً، في روايات عبده)، وهو نفسه يحكي أنه، حين كان طفلاً، مرض مرضاً شديداً، أوهنه حتى كاد يقضي، فكانت أمه تضع كامل جسده، في حفرة بحجم طوله، ثم تطمرها بالتراب، حتى ذقنه. ولشهر أو أكثر كانت تعاود وضعه يومياً لساعات، من النهار، بتلك الحفرة، وكانت هذه طريقة شائعة من الطب الشعبي، بمنطقة جيزان، وأماكن أخرى! يتذكر عبده تلك الدفنة اليومية، ويصف كيف حط أحد الطيور على رأسه، يوماً، وكاد ينقر عينيه، دون أن يستطيع هشّه وإبعاده! استعاد الطفل الصغير بعض عافيته بعد مدة، فعمدت أمه لتغيير اسمه إلى «عبده»، فقد كان اسمه الأصل «عبدالرحيم».. كسراً لشؤم أوجاعه، وهذه عادة عربية قديمة، كما هو معلوم!
بعد تلك الليلة القديمة، بأبها، تعمّقت صداقتنا ووصالنا، وكانت تجمعنا الفعاليات الثقافية، من عام لآخر. التقينا مرة في بيروت، ربما كان هذا في بيروت 2004م، وكنت للتو أصدرت مجموعتي الشعرية الأولى (ألهتك). أعطيته نسخة، بابتهاج العمل الأول وطفولته، ولا أنسى حفاوته وفرحه الصادق، وكلامه عن نشوة أول كتاب. قضينا وقتاً كبيراً، في ليالي بيروت السعيدة، حين كنا نأتيها، ولا نغيب عن معارضها، ولا زياراتها لغير ما سبب، تلك السنين، بلا قلق، كان هذا قبل أن تُختطف تلك المدينة الرحبة، بالنزاعات والمليشيا والتصفيات، وينفر منها اللائذون بسعتها، وتستحيل إلى مكان للخوف! كان عدد من أحبابنا؛ المثقفين اللبنانيين، قد غضبوا من أدونيس، حين قال ما فحواه، مع زاهي وهبي؛ إن بيروت كانت مدينةً أفقية، لكنها توقفت عن ذلك! وأظنهم الآن، وبعد الأحوال الحزينة جداً، الراهنة.. يوافقونه!
انتقلت إلى مدينة جدة في أبريل 2006م، ليبدأ زمن هو الأجمل والأقرب، في صداقتي بالغالي والعالي، عبده. تعرفت على مجموعة رائعة من الأصدقاء، من خارج الوسط الثقافي، المرهق أحياناً، نلتقي أسبوعياً، على شغف الطرب، وكرة القدم، بعيداً عن هراء العالم، وسحبت (أبو وشل) إليهم، لمجلسهم. ومن أول لحظة، سلب عبده ألبابهم بعفويته، وطيب الخاطر، وصفو البال والسريرة، وتعمقت صحبته بالمجموعة، حتى السفر، أكثر من مرة، خارج السعودية، وما أعذب السفر معه، هذا النحيل، بعلاته الصحية، يستحيل إلى عافية الرفقة، وطعم الرحلة!
أما عبده وأنا، فمنذ ذلك الوقت، ونحن لا نكاد ننقطع، ولأقل إن هذه المرحلة هي الأوضح، التي اكتشفت فيها إنسان عبده، الداخلي الخرافي، عن كثب، ولا أدري ما أقول عنه ويكفيه، لكنني أؤكد لكم أن أي كلمات سأكتبها، أو وصف أو طبيعة، سأحاول تقريبها لكم، لن تقترب حتى من حقيقة معناه، وكل ما يمكنني قوله هو: إن عبده كينونة مكتملة وباهرة، من الجمال الإنساني، العفوي، الطفولي، الصادق!
تربط عبده علاقة ملائكية، بشقيقتيه الكبيرتين، اللتين يعاملهما كأمه، بعد وفاتها، رحمها الله، فلم يدر لهما ظهره، حتى وهما في بعض كفاية عائلتيهما، بل لم يفتأ يحمل عنهما عنت الأيام، ومكابدات العيش، بلا كلل، ولا منة، أو تباهٍ، وأعرف ما لو قلته، من عنايته بأدق تفاصيلهم، ولو كانتا في غير حاجة، لغضب مني! واسمع عبده، وهو يتحدث إليهما معاً، أو إحداهما، على انفراد، وستسمع سيلاً من الرقة والعاطفة! قلت له مرة: «والله -يا صديقي- وأنت في زحام حياتك هذا، فإنه وفيٌّ وعظيم وصلك هذا بأختيك». قال بنبرة حادة: «ايش تقول! ما لي فضل، هذولا جنتي، أمهاتي بعد أمي».. وهذا تطبيق حي للمثل الرائج، لدى معظم شعوبنا، الذي يدل على مروءات العربي، حيال أهله: «اللي ما فيه خير لأهله.. ما فيه خير للناس».
أما عبده، وعلاقته بأسرته، بزوجته وأبنائه، فهو عائلهم وصديقهم، وعاشقهم، وأبوهم الكبير، من جهة، وهو طفلهم الصغير، من جهات! زوجته، ورفيقة العمر والمشوار، السيدة الفاضلة، والفنانة التشكيلية حنان الجهني. وعبده لا يتوقف عن وصفها بـ«النعمة»، ويضيف: إنها احتملته، واحتملت معه متاعب عمره الشاق.. «ليس بالصبر فحسب، بل بالحب»، بالنسبة لأبنائه فيا لها من علاقة عجيبة، لم أره يوماً يتصرف معهم، أو يخاطبهم، بسلطة الأب، بل بحميمة صديق عمر، وهذا نقل إليهم بعض طبيعته الودودة! قبل أشهر عدة، كنا مدعوّين لمهرجان السينما، في مركز الملك عبدالعزيز (إثراء) في شرقي البلاد، وصعدنا على الرحلة نفسها، من جدة إلى الدمام، وليصادف أن ابنه (معن)، الذي التحق مؤخراً للعمل في الخطوط الجوية السعودية، كان مع ضمن طاقم الملاحة، لتلك الرحلة. كان (معن) يجيء ويروح إلى مقاعدنا باستمرار، طوال التحليق، نمازحه ويسأل عما نحتاجه! في لحظة.. لمحت عيني عبده تترقرقان، وظننت أنني التقطت شعوره حينها، قلت له: «لا تلام، يا صديقي، شيء مؤثر حقاً أن ترى أبناءك، وقد كبروا لهذا الحد! الطفل الذي أنجبته وربيته وكبّرته.. وها هو اليوم يخدمك، على أول رحلة، تجمعكما!». سكت قليلاً، ثم قال: «صحيح، لكنه ليس هذا، يا عبدالله!» وراح يتحدث عن أحلام ابنه، وشغفه بالسينما، التي نحن في الطريق إليها، وتحديداً بفن (الإخراج)، لكن الظروف لم تسعفه، والتزامات الحياة ضاغطة، لا سيما بعد زواجه، ثم رفع رأسه ليرى إن كان ابنه قريباً، وقرب رأسه، وتكلم همساً: «الطيارة مليانة بالشباب المخرجين من جيله وأصدقائه. رحلة صعبة عليّ وعليه، يا عبدالله!». لم أجد ما أعلق به على هذا الشعور الأبوي، شديد الحرارة والحرقة، غير الكلام العادي والمكرور: «فوات الأحلام مؤلم. أفهمك، لكن العمر قدامه، يا صديقي، لا تحزن!». ولم يجب! صمت لدقيقة، ثم بدّل الموضوع، وأخذ يطلق تعليقاته المرحة، ويقهقه. وهذه إحدى عادات عبده، إنه يداوي حرقاته سريعاً بالضحك!
علاقة كبيرة أخرى، وربما هي الأكبر، في قلب عبده وحياته، وهي صلته بابنته الصغيرة والوحيدة (جوى)، وكلما كبرت هذه الفتاة، شديدة الذكاء، تعلق بها عبده أكثر وأكثر، فهي جذوة نفسه، ومرتبة شؤونه، وأمينة سرّه. حين ذهبت جوى للدراسة بفرنسا، كادت روحه تنصرم عليها! ضع اسم هذه الملاك الصغيرة، في أي موضوع، وخذ بعدها من عبده ما تشاء، فقد صارت الطريقة الأخيرة والوحيدة، ليتنازل عبده عن عناداته، لا سيما المراجعات التي تخصّ صحته!
عبده خال.. ابن حارة الهنداوية، في جدة، وهذه الحارة تمثل له كنز العمر، وصلته بها، وبذكرياته وأصدقائه فيها، لا نهاية لها. إنها تكوين طفولته الكبير، ومرتع صباه، وأول شبابه. وهو بالمناسبة يشتغل على راوية بنفس اسمها (الهنداوية)، منذ عشرين عاماً، وإذا سألته: «لماذا لا تكملها وتخرجها؟»، يجيب فوراً، بيقين: «إذا انتهيت منها وأخرجتها.. سأموت».
الحارة نفسها لا يغيب عنها عبده، يعتاد أزقتها، ويلتقي أصدقاءه فيها، من حين لآخر، وسترى حقيقة ارتباط عبده، بهذه الهنداوية العجيبة، في شهر رمضان ستجده ليلياً هناك، على «مركاز» هنا، أو «بسطة» هناك، في تحديات لعبتي حجار «الضومنة»، أو ورقة الكوتشينة «البلوت»، حتى السحور.. وطلعة الشمس أحياناً!
بقي الكثير لأتحدث عنه، لكن هناك ما يجب أن يعرفه القراء.. وهو أحداث معرض الكتاب الدولي، التي كاد يذهب ضحيتها، في تلك الفترة القاتمة، حين كان الظلاميون «المحتسبون» المتطرفون يصولون ويجولون في المعرض، وفي كل البلاد، ما قبل التحول البهيج، الذي تشهده السعودية، برؤيتها العظيمة 2030م، بقيادة الأمير الشاب الرائع ولي العهد محمد بن سلمان، في السنوات الأخيرة، التي خلقت واقعاً مفاجئاً وعظيماً! وإليكم هاتين الحادثتين، من معرض الكتاب، ولكم أن تتخيلوا، بالقياس، ما كان يحدث خارجه، في تلك الحقب المريعة: الأولى.. كنت وعبده، والناقد والأديب د.معجب الزهراني، نتجول في المعرض 2008م، وسمعنا النداء الداخلي بالإعلان عن حفل توقيع للكاتبة السعودية «حليمة مظفر»، فاتجهنا إلى منصتها، دعماً لها، لنفاجأ بعزلها، وعدم السماح للرجال بالاقتراب، بوجود أعضاء من الهيئة، فجادلناهم للحصول على نسخ موقعة. رأتنا الكاتبة من بعيد، فأعطت موظف الأمن النسخ ليسلمها لنا. فقمت بدوري بالتلويح بيدي، وقلت فقط: «شكراً حليمة»، وفي غمضة عين ألقت الهيئة القبض علينا، وأمام الجموع في المعرض قاموا بسحبنا، كالمجرمين، إلى مركز الهيئة، والتهمة «إلقاء التحية على امرأة أجنبية»! لن أتحدث عن نفسي ومكانتي، لكن لك أن تتخيل أن روائياً كبيراً بحجم عبده، وناقداً وأديباً وأستاذاً جامعياً، بموقع د.معجب، نعامل بهذا الشكل المهين! وللتاريخ فإن معالي وزير الثقافة حينها، د.عبدالعزيز خوجه، ظهر تلفزيونياً في حوار مع الأستاذ أحمد عدنان، وقدم اعتذاره لنا، في سابقة محترمة وشجاعة!
الثانية: وهي في العام التالي 2009م، وهي التي ألمحت لها، بداية المقالة، ففي آخر ليلة لعبده في المعرض، كنا معاً كالعادة، وطيلة ما كنا نتنقل بين دور النشر كان المحتسبون المتطرفون يستوقفوننا، ليهاجموا عبده، وهو يرد عليهم، بلا خوف، حتى حينما قررنا مغادرة المعرض، لنذهب للعشاء، لحقوا بنا في الساحة الخارجية، وبضغط أكبر التفوا على عبده مجدداً، يكفرونه ويشتمونه، وتوشك أيديهم بالاعتداء عليه، وهو والله أعمق منهم بألف دهر، إيماناً واعياً وصادقاً وروحانية! بالكاد تخلصنا منهم، ومضينا. بدأ عبده طيلة الطريق للمطعم، ثم الفندق، يشتكي من رأسه، وظنناه صداعاً عادياً! لحظة وصولنا للفندق حاولت إقناعه بتأجيل رحلته، في الفجر، قال «طيب» وذهب كل منا إلى غرفته. والذي حدث -للأسف- أن عبده لم ينم، وفي منتصف الليل ذهب للمطار، وصعد على الرحلة، وصداعه يتضاعف، وهو يكابر ويعاند. وصل إلى جدة، وبمجرد دخوله منزله.. انهار! طلبت عائلته سيارة الإسعاف، ونقلوا عبده إلى المستشفى، فاقداً وعيه بالكامل، ليتضح للأطباء أنه أصيب بجلطة دماغية قاسية، في ذهول كبير، كيف احتمل آلام ذلك الصداع، وتصاعده تدريجياً، ثم كيف استطاع ركوب الطائرة! أفاق (أبو وشل) فاقداً للنطق، كانت الجلطة هناك، لكنه نجا منها بأعجوبة، والأمل أنه سيستعيد بعض لسانه، بمرور الوقت. وما زالت آثارها على نطق عبده، حتى اليوم، ومن يعرفه وانطلاق كلامه قبل الجلطة، يعرف الفارق الكبير بعدها! وباختصار.. كاد الظلاميون يفتكون به، برأسه العالية، لكنه كان وما زال أقوى منهم، ولو مسته بعض ضغينتهم العمياء!
في السنة التالية 2010م أحرز عبده جائزة البوكر، عن روايته الشهيرة (ترمي بشرر)، في إنصاف وعدالة صغيرة، من عدالات القدر القليلة، وكان هذا واحداً من أكبر ردود الحياة على أعدائها، وانتصاراً لواحد من أخلص أبناء معناها وجمالها! لقد كان إعلان فوز عبده، في مكبرات الصوت، في معرض الرياض -المعرض نفسه، الذي كاد يقضي ضحيةً لمهووسيه وتطرفهم- لحظةً مجنونة، أشبه بتسجيل ضربة جزاء حاسمة، في نهائي ساخن، هتف جمهور المعرض كله ليلتها، بصيحة واحدة، حباً واعتداداً بعبده وكتابته، ودوماً أقول لعبده، الذي كان في مسرح الحفل، في مدينة أبوظبي، بالإمارات: «ليتك رأيت ما حدث، يا صديقي، ليتك رأيت! كنت شعرت بالعزاء، لآخر العالم!
وهذه إشارة صغيرة، لأثر عبده، على الكتابة عربياً، وعلينا في السعودية بالأخص، وبالأخص أكثر على الأجيال، التي تلته، فعبده الذي بدأ مستقلاً، عن اختطاف الأيديولوجيات، يساراً ويميناً، كان الحلقة العضوية الواعية والواصلة، بين أجيالنا، نحن الآتين والمنقطعين، من بعده، وبين حركة الأدب في السعودية، منذ نشأتها، وبعيداً عن الانتشار المضاعف، الذي حققته له البوكر، فقد كان عبده خال، وما زال، مثالاً رفيعاً للكدح والتقدم!
أخيراً.. هذه تلويحة قديمة، أعيد بعثها لعبده، حافلاً وفرحاً به:
أتذكر لما قلت لك: إن الليل، ليل هذا الوجود الشاسع، وهو يتمطّى في نواحي الأكوان، ويطلي المجرات بسواده المطلق، بضربة خاطفه، بأدق ريشة، من جناحه الهائج! أتذكر لما قلت لك: إن الليل حين همّ باقتحام مجرتنا العزلاء، لمح بداخلها كوكبنا الأرضي الصغير، يدور حول نفسه، بارتباك حزين، عالقاً في لونه الأزرق، حينها قرر أن يبدأ به، قال: سأعلم كائناته عدّ الليالي والنهارات، وملاحظة النجوم، وأمزجة الخلائق! وقبل أن يفعل أي شيء، رأى ورقةً مطويةً وملقاةً، على أحد جانبي طريق، من الطين، كتبها فتى بالغ النحول، مرقطاً بالأوجاع والأساطير، وهو يحاول أن يبتكر ملامح امرأة مقهورة وأقدارها، في حكاية، لم يكملها بعد.. فكتب إليها: «ماذا يُضيرُ لوْ أنني وجدتكِ صُدفةً، في شبابي، وخرجنا في نزهةِ حبٍّ، ولم نعُد إلا للحودنا، وينتهي الأمر والعمر، في نزهةٍ قصيرة، ربّما كنا خلالها قطفنا العالم، ولهونا به قليلاً، وعدنا للأرض، لنكون سنبلتين متجاورتين. بالله عليكِ ماذا يُضير؟!».
حسناً، يا عبده، أريد أن أقول لك: إنك تكتب، حين تكتب، وكأنك سبقت الليل بخطوة، ورأيت أسى أرضنا البشرية، بوضوحها التراجيدي الأول! وهكذا تلتقط لنا دهشة العالم، يا صديقي، كلما أخذت تشرع في خلق رواية جديدة، فاكتب.. اكتب، وأنقذنا من كوكبنا!
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عكاظ ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عكاظ ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.